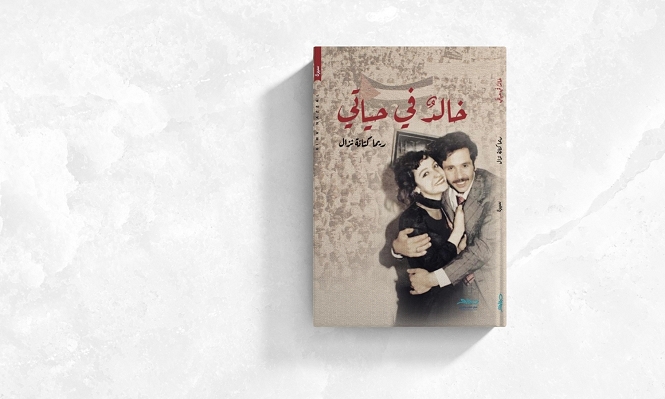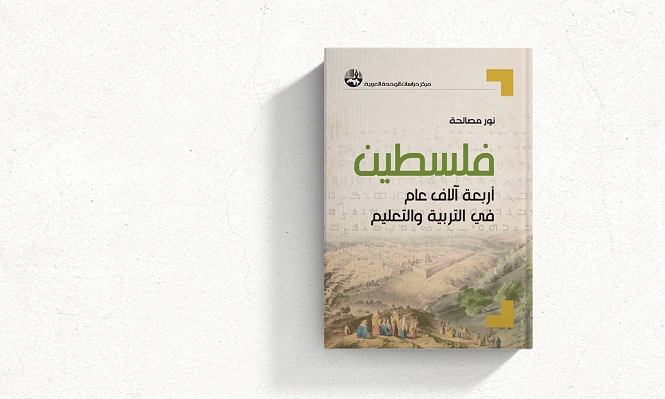مشوار | مقطع من الخيمة البيضاء
وبين الاسمين الأوّل والأخير كان يُدعى "ميدان المغتربين". ومع أنّها ظنّت لوهلة أنّ تغيير الاسم كان بوحي من أولئك الفلسطينيّين الآتين من خارج فلسطين؛ أي "العائدين"، فإنّها عرفت أنّ اسم "المغتربين" يعود إلى فئة من مواطني رام الله القدامى...

'الخيمة البيضاء' رواية للكاتبة الفلسطينيّة ليانة بدر، صدرت مؤخّرًا عن دار نوفل اللبنانيّة (هاشيت أنطوان العربيّة)، وهي تقع في 280 صفحة من القطع الكبير. صورة الغلاف بعدسة صاحب الرواية، وقد صمّمته ماريا تريز مرعب.
جاء في موقع دار نوفل تعريفًا بالرواية: 'إنّها رام الله في الصباح. تبدأ الرواية في دوّار وسط المدينة حيث قلبها النابض، وتستمرّ خلال أربع وعشرين ساعة لكي تكتمل فصولها على حاجز قلندية. ما بين العلاقات المرتبكة والحواجز والجدران وتصوّرات الأفراد عن ذواتهم وقصص الأمكنة، هل يمكن للرواية أن ترسم ما يخلخل الصور المألوفة بحثًا عن وقائع الشخصيّات، وعن أحلامها التي بدأت تتبخّر، على الرغم من اليقين بوجودها؟!'
تنشر فُسْحَة – ثقافيّة فلسطينيّة مقطعًا من الرواية تحت عنوان 'مشوار'، بإذن من مؤلّفتها.
***
مشـوار

ستعرف الليلة ما يحدث في بيتها، ولن تنام حتّى لو هدّها النعاس. ستستدلّ على ما يحدث في تلك الغرفة المغلقة حيث يقوم الشابّ والصبيّة بالدراسة. وسوف تعرف بالتأكيد مع مَن تُجري كلّ هذه الاتصالات الليليّة. تسمعهم وهم يتحادثون على موقع 'سكايب'، فيخبرها قلبها الواجف بأنّهم يرتّبون شيئًا يحاولون إخفاءه بعد ليلة 'الفيس بوك' تلك. بالتأكيد. لا بدّ!
في 'ليلة الفايسبوك' كانت الأمور هادئة إلى أن دهمت مجموعة من الجيش البناية لتتّجه إلى بيتها وتفتّشه فقط تحت حجّة 'إجراء روتينيّ' حسب الادّعاء. نشف ريقها من الرعب عليهما؛ ابنها خالد وبنت الجيران، وحمدت الله في سرّها ألف مرّة لأنّ ابنها الأكبر يعمل ويتابع دراساته في الخارج حيث يقيم والده. فتّشوا الدار، وفتحوا أدراج الخزائن، ونكشوا ما شاء لهم، ولم يبقوا شيئًا في مكانه، بل عاثوا فسادًا في المطبخ، وخلطوا الرزّ بالسكّر بالدقيق، وهم يسكبون المرطبانات، بعضها فوق بعض، بسرعة خياليّة من دون أن تقدر على ردّهم أو الحديث معهم. أمروها بالجلوس مع الفتاة والشابّ على طاولة الطعام في غرفة الجلوس، وحظروا عليهم الخروج. وكيف لهم بالخروج أصلًا والجنديّ المسلّح حتّى أظافره يحمل بندقيّة، ويسدّ باب المطبخ، فيما الآخرون يقومون بالتفتيش داخل البيت. في النهاية، وبعدما سئموا من عدم وجود ما يشبع لهفتهم بعد الدوران على جميع الأدراج والخزانات والصناديق والزوايا، تقدّم ثلاثة من المجموعة إليهم في المطبخ، وجعلوا الفتاة والصبيّ يفتحان جهازي اللاب توب الخاصّين بهما، كي يراقبوا المواقع الأخيرة التي زاروها، ثمّ طلبوا منهما فتح صفحاتهما على 'الفيس بوك'.
تفرّجوا، وتصفّحوا، وتشاوروا بينهم، ثمّ أعلنوا انتهاء المهمّة قائلين: فحص روتينيّ.
لكنّ أحدًا من المجنّدين كان يرتدي نظّارة طبّيّة، فيما يدلّ مظهره الممتلئ على تثاقله عن المشي والاستنفار معهم، لم ينسَ أن يفتّش على صفحة مغنّية عبريّة مفضّلة لديه بعد إعادة إغلاق صفحتيهما.
يا ربّ، في ليلة 'الفيس بوك' تلك أوشك شعرها على أن يشيب. فماذا يخبّئان لها الآن؟
كلّما سمعت أصواتهما، كادت تصاب بانهيار عصبيّ، ولا تتعلّق المسألة بالثقة على الإطلاق، فهي تعرفهما جيّدًا، وواثقة من أخلاقهما. دومًا كانا مثل أخت وأخيها، مثل شقيق وشقيقة. لكنّ ما يريبها ذلك الصوت الغريب الذي يعقبه نقر أو شيء أشبه بالتصفيق وانطفاء غريب لموسيقى ذات إيقاع خشن. وفي كلّ مرّة، يذوب الصوت لحظة وصولها إلى الباب. مع أنّها تخفّف من وقع خطوها في كلّ مرّة تحمل فيها صينيّة الشاي أو القهوة، وتمنع نفسها من إصدار أيّ صوت، حتّى لو حفيفًا بسيطًا لثيابها، لكي تنصت بتركيز إلى ما يسمعانه.
معقول أنّ غباءً ما يطيح برأسيهما، فيتركان مشاريع الدراسة الملحّة، ويستمعان إلى الأغاني التي اشتُرِطَ على أن لا يقرباها خلال فترات الدراسة. وما هو ذلك الصوت البشريّ المجهول الذي يتناهى إليها ما بين أغنية وأخرى؛ حين يلجآ إلى استراحة قصيرة بين الحين والآخر من أجل إنعاش نشاطهما.
هل أصيبا بالجنون لكي يقوما بعمل ما بدلًا من متابعة كتابة الأوراق التي عليهما إنجازها؟ والآن في عزّ الامتحانات الفصليّة!
ستكتشف كلّ هذا. لا بدّ!
وتمشي كأنّها شبح 'زومبيّ' يقوم من سباته، وهي تُهَمْهِم وتعاود ترديد العبارة:
معقول، يا ربّ. معقول!

لكن العجقة تبتلعها وهي تحسّ بأنّها تطفو بين الناس، وأنّها تضيع بين السيّارات التي يزاحم بعضها بعضًا وهي تطلق زماميرَ قويّة ومتلاحقة. يدوم الجميع بأصوات مختلطة مثل قفير نحل خرج كلّ من فيه محلّقًا برعونة وجنون، وهي وحدها التي تعبر بين أجساد آدميّة متلاصقة في حيّز ضيّق.
وكما في كلّ يوم عندما تعبر قرب دوّار 'الساعة' متّجهة إلى منطقة الإرسال عبر المنارة في وسط رام الله، يراودها طيف قطع السكاكر المستطيلة المطبوخة بيتيًّا 'السمسميّة'، فتزيحه عن خاطرها كمن يطرد ذبابة غير مرغوب فيها.
كم تغيّر اسم هذا الدوّار مرّات عدّة، وبدا عليه كأنّه لن يكفّ عن التبدّل. كان اسمه في البداية 'ميدان الساعة' حين كان يضمّ ساعة كبيرة معلّقة على عموده الحجريّ الذي يتوسّط المكان. ومؤخّرًا غيّرت بلديّة المدينة اسم الميدان إلى 'ميدان ياسر عرفات' بعد رحيل القائد الكبير.
وبين الاسمين الأوّل والأخير كان يُدعى 'ميدان المغتربين'. ومع أنّها ظنّت لوهلة أنّ تغيير الاسم كان بوحي من أولئك الفلسطينيّين الآتين من خارج فلسطين؛ أي 'العائدين'، فإنّها عرفت أنّ اسم 'المغتربين' يعود إلى فئة من مواطني رام الله القدامى الذين اعتُبروا 'المؤسّسين' وأتوا من قرية صغيرة جنوب الأردن، قاموا بالجلاء منها، واستوطنوا المكان الحاليّ قبل هجرتهم المتزامنة مع 'السفَرْبَرْلِك' إلى ما وراء البحار. ولا تنطبق هذه الصفة عليها، لأنّ والدها من القرى المحيطة بالقدس، ووالدتها من مدينة بيت لحم. أمّا هؤلاء المقصودون بالاسم الجديد، فهم من كانوا محورًا حيويًّا في كلّ صيف يعودون فيه من مدن الاغتراب كي يقضوا إجازاتهم مع عائلاتهم المقيمة؛ غالبًا في موطنهم. لذلك كُرّموا بإطلاق الاسم على 'دوّار الساعة' الذي يحتلّ موقعًا حيويًّا في وسط المدينة.
هؤلاء، أهل رام الله الذين اعتُبروا 'أساسيّين'، كانوا قد رحلوا من الأردنّ هربًا من قضيّة ثأر إلى تلك الروابي المنخفضة في رام الله التحتا، شرق الهضاب العالية التي احتلّتها قرية البيرة. وهكذا تحوّلت رام الله من قرية صغيرة إلى بلدة كبرت وامتدّت بين زمن وزمن. شيئًا فشيئًا زحفت القريتان التوأم باتّجاه بعضهما إلى أن توحّدتا، وصار يُطلق عليهما اسم واحد، على الرغم من أنّ بعض أهالي البيرة ورام الله ما زالوا يتجادلون حول أيّ واحدة منهما كانت البلدة الأقدم والأكثر عراقة من الأخرى.
لكنّها هي، مثل كثيرين غيرها، ظلّ اسم المكان لديها هو هو. ستظلّ تعرفه على أنّه ميدان 'الساعة' التي كانت تشاهدها على رأس العمود المثبت في الوسط هناك، حتّى لو قرّرت البلديّة تغييره ألف مرّة.
حينما تصل تميمة إلى 'دوّار المنارة' في طريقها إلى مكان عملها في شارع الإرسال، فإنّها تكون أكيدة من أنّها سوف تشاهد مربّعات حلاوة السمسيّة ذات اللون العسليّ معروضة على بسطة جنب الرصيف وملفوفة في ورق السوليفان الرقيق. وتعرف تمامًا حينها أنّها، كالعادة، سوف تتهرّب من شرائها، بل ومن النظر إليها. إلّا اليوم، فلا شيء يمكن له أن يحرّك أشواقها إلى الطفولة، وهي تعاني من عقلها المشتّت وأفكارها المبلبلة بشأن ما يجري في غرفة الدراسة تلك في بيتها كلّ مساء.
تتجنّب التفكير في موعدها الجديد غدًا، لأنّها تريد أن تنسى 'القضيّة الأخرى' التي تطوّعت للمساعدة فيها. الفتاة الشابّة التي تتّكل على مساعي صديقاتها وعليها هي، أيضًا، لإنقاذها من براثن الموت. الفتاة التي أحبّت ولم يغفروا لها، لأنّ من تقدّم لخطبتها لا ينتمي إلى العشيرة. ستفكّر مساءً في الموضوع، كما فعل امرؤ القيس، فاليوم 'خمـ ... وغدًا أمر'.
لن تستدعي الاضطّراب إليها إلّا بعد أن تفكّر في طريقة مساعدتها الناشطات على نقل الفتاة المهدّدة من موقعها الحاليّ إلى القدس، من دون أن ينتبه أحد إلى ما يجري.
ستفكّر الليلة، وتقلّب الأمر في رأسها، وتشبعه تمحيصًا.
تهرب من خواطرها القلقة بالنظر إلى البسطة التي يعرض عليها البائع حلواها المفضّلة.
تدير وجهها إلى الأعلى ناظرة إلى البنايات التي تحيط 'المنارة'، وقد عُلّقت عليها مئات اللافتات التجاريّة ولوحات الدعايات الضخمة التي تخنق فضاء هذه المنارة التي لا تشبه المنارات البحريّة أبدًا. هل حلم يومًا أهل البلدة الصغيرة بالبحر يقترب من شواطئهم، فأقاموا هذا العمود القديم وسمّوه 'منارة'!
تضغط على أعصابها وهي تتصفّح التغييرات المتسارعة التي أدّت بالمكان إلى أن لا يعود يشبه نفسه الأولى. وسط المدينة هذا صار أشبه بمحطّة قطار ممتلئة لا فقط بملصقات الدعايات التجاريّة التي تفغر أفواهها الحمقاء من كلّ الأسطح والجهات، وإنّما أيضًا بكلّ ما هبّ ودبّ من إعلانات وخطابات تحتلّ الحيطان. تتراكم العبارات السياسيّة التي خطّتها الأيدي منذ سنوات فوق الملصقات الانتخابيّة، التي تكاثرت واختلطت مع صور الشهداء على الجدران؛ تلك التي تجمّعت وتقشّر بعضها فوق بعض ونحلت كأنّها رسوم خفيّة لبقايا أصحابها. أوراق وشعارات وملصقات تمازجت مع الدعايات التجاريّة المعلّقة بكلّ ما تحمله من دلائل البيع والانتشار. وذلك الصمغ حولها وقد تحوّل مع الزمن إلى نوع جديد من الرسوم المليئة بالرموز والإشارات، بحيث لا يعود المرء يفهم من هذه اللغة المختلطة شيئًا.
لم تعد تمشي هنا براحة بعد أن امتلأت 'المنارة' بعشرات المتاجر ومحلّات بيع الطعام والعصير، وصار الميدان أشبه بمحطّة للعابرين المؤقّتين الآتين من قراهم إلى ما يظنّون أنّه قلب المدينة. هنا حيث تصطفّ الأسود الحجريّة في وسط الدائرة كأنّ مدرّب سيرك مجهول نسيها هناك حتّى تجمّدت بسبب لعنة سحريّة ما.
صحيح أنّ هذه الدائرة الحجريّة تدّعي أنّها مركز المدينة، لكنّها بطريقة ما كانت لها حياة سرّيّة شارك فيها الجميع.
في البداية كانت المسيرات التي يشارك فيها الأطفال والفتية تتشكّل ظهرًا من وسط المنارة، كي تنطلق إلى الحاجز الإسرائيليّ في شمال المدينة. وكانت التجمّعات الشبابيّة العارمة في عزّ منع التجوّل تعتصم ليلًا هنا أثناء حصار الرئيس عرفات في المقاطعة. كم تمتّع الشبّان بالجرأة حينذاك لكي يكسروا منع التجوّل الصارم الذي يهدّد الحياة حين يتحرّك أيّ مخلوق. كم تسلّل خالد وأصحابه في العتمة هنا من دون خوف من الدبابّات وقنّاصيها. حتّى إنّ جارتها الصيدلانيّة، التي لم تغادر دوامها خلال الانتفاضتين الأولى والثانية، أخبرتها أنّ بعض موزّعي الأدوية ممّن حُصِروا داخل مكاتبهم وسط المدينة خلال الاجتياح 2002، لم يستطيعوا العودة إلى بيوتهم أيّامًا طويلة، فصاروا يأتون إلى هنا ليلًا للمساهمة في إرسال الأدوية إلى كلّ من لا يستطيع الخروج من مخبئه.
وهي نفسها لا تنسى أنّ الوفود الأجنبيّة التي تضامنت مع عرفات في حصاره الطويل داخل المقاطعة، كلّها كانت تمرّ من هنا باتّجاه المقاطعة غصبًا عن الدبّابات، ورغم أنف منع التجوّل.
للجميع ذكريات عن 'المنارة'؛ قلب المدينة النابض أبدًا، مثلها. كانت تتذكّر أشياء عن النافورة الصغيرة في الميدان المجاور، التي تمنّت لو استطاعت النزول فيها في صغرها. وكان يتهيّأ لها أنّها كانت تقف هنا دائمًا أيّام طفولتها؛ لأنّ عائلة عمّها وصغارهم كانوا يصطحبونها معهم حين يتذكّرونها. وما كان بإمكانها وبإمكان إخوتها إيجاد من يأخذهم خارج الدار إلّا معهم، فأمّها لا تعرف السياقة، ووالدها كان 'الغائب أبدًا' في لبنان.
أيّامها كان الكبار يجلسون على طاولات 'نعوم' الأنيقة لاحتساء شاي العصر. ويسمحون للأطفال بالتجوال قريبًا من المكان. وحين يتسلّل الأطفال إلى هذه الدائرة، كانت المياه تتدفّق من أفواه رؤوس أسود صغيرة الحجم وسط البركة الصغيرة، التي تقبع بأحجارها الخشنة داكنة الألوان في المنتصف، على الرغم من أنّ سورها عال لا يسمح بالنزول فيها، مهما دارت الأمنيات في رؤوس الأطفال المحيطين بها.
ذلك المكان لم يكن هو، ولم يعد يشبه نفسه أبداً.
لكنّها تعاني الآن من القلق الطاحن لأنّ سرًّا ما يُحاك في بيتها، ومن وراء ظهرها، وهي لا تعرف ما الحكاية!
يكفيها أنّها سوف تشارك بشكل سرّيّ في تهريب الفتاة المطاردة وحمايتها من سيف التهديد بالقتل الذي يُلوّح به بعض أهلها. يكفيها أن ترتجف رعبًا من أن لا تنجح الخطّة، خصوصًا بعدما حاول واحد من أقارب الفتاة التصويب عليها، فأصاب يدها بجرح سطحيّ، ولم يفلح في قتلها.